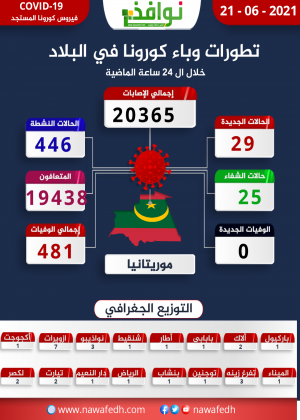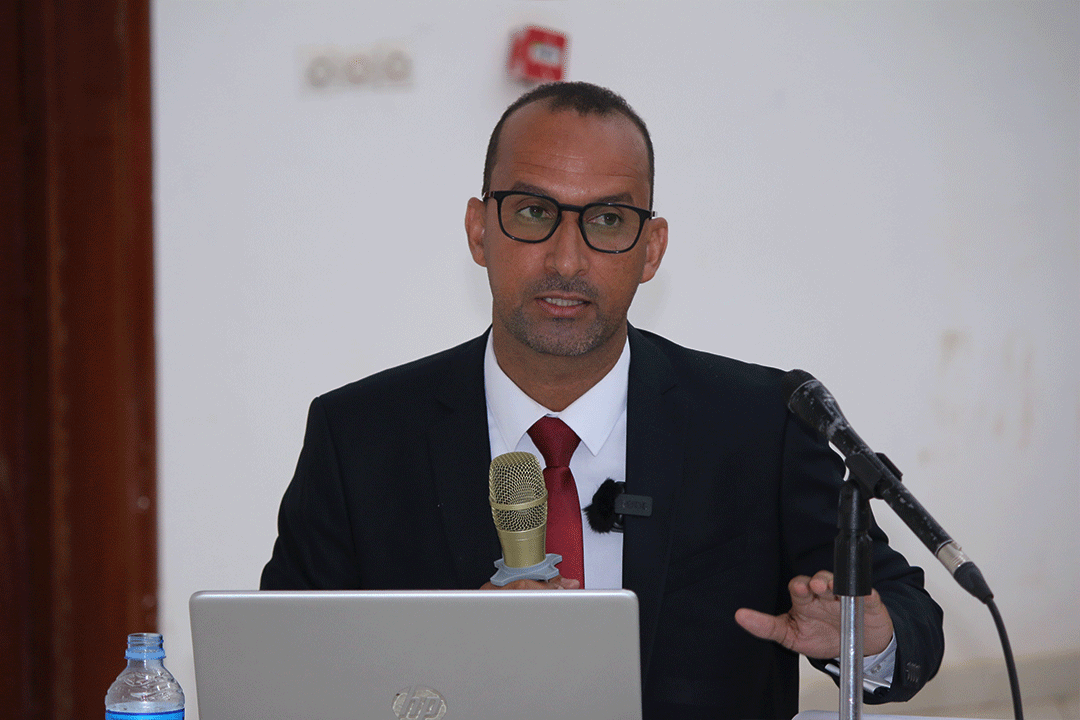
نوافذ(نواكشوط) ــ حصل المدير الناشر لموقع "نوافذ" الزميل عبد المجيد إبراهيم على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع تنويه اللجنة بالعمل، بعدما ناقش أطروحته اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 بكلية الآداب بجامعة نواكشوط العصرية.
ونال ولد إبراهيم وهو صحفي مشهور شهادة الدكتوراه في تخصص مناهج البحث في اللغة والأدب، حيث تقدم بأطروحة بلغت 336 صفحة موسومة ب:"سردية المقامة في الأدب الموريتاني: سياق الظهور وخصوصية النص".
ووفقا لملخص الذي قدمه الطالب الباحث أمام لجنة النقاش فإن هذه الأطروحة تسعى في أبعادها التطبيقة إلى الكشف عن مكان السردية ، ومآتي الحسن والجمال في المقامة الموريتانية، كما كتبها الكتاب الشناقطة قديما، والموريتانيون حديثا في لحظات تطورها الثلاث؛ وفق منهج نقدي محدد ولغايات علمية ومنهجية مضبوطة، والمنهج النقدي المتبنى هنا أداة لإنتاج المعرفة واختبار الأطروحة يتبنى السرديات وتطبيقاتها على النص السردي، في خياريه الوصفي (الواصف لسردية المقامة)، والتاريخي (المؤرخ لظهورها في التجربة الشنقيطية، وهما خياران يدخلان في اللحظة الثانية من مراجعة أطروحة السرديات التوسيعية، ويكشفان عن مستويات من الوعي بأطروحة السرديات ما بعد الاكلاسيكية في التجربة العربية، والتي تعمقت مداركها النظرية والمنهجية، مع ظهور الجيل الثالث من السرديين العرب المنشغلين بتطبيقاتها في الترجية العربية.
وأكد ولد إبراهيم في تقديمه أن هذه الأطروحة إلى إنصاف هذا الشكل الأدبي، بتأطيره في سياقه السردي، وتحليله عبر عدسة منهجية متأنية، تعتمد السرديات التوسعية، بوصفها أداة نقدية تكشف البُنى العميقة للنصوص، وتفكك آليات اشتغالها، دون الارتهان لافتراضات مغلقة، أو مقاربات اختزالية.
وقد تكونت لجنة نقاش الأطروحة من:
الدكتور محمد ولد تتا رئيسا
الدكتور محمد الأمين مولاي إبراهيم أستاذا مشرفا
الدكتور سعيد يقطين/ مقررا
الدكتور محمذن المحبوبي/ مقررا
الدكتور أحمد حبيب الله / مناقشا
وقد تميز النقاش بحضور نوعي شمل وزراء سابقين، ونوابا، وضباطا، وأساتذة جامعيين، وسياسيين بارزين.
وهذا نص تقديم الباحث عبد المجيد إبراهيم لأطروحته:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضرة الفكر والعلم، حيث تلتقي الأسئلة بالبحث، وتتشكل الحروف من شغف المعرفة، أقف أمامكم اليوم لأقدم ثمرة اجتهادٍ، وبذرة حلمٍ نبتت في تربة السعي، وسُقيت بالتعب، ونضجت بفضل الله أولًا، ثم بفضل من كان لهم الفضل بعده.
أتوجّه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى لجنة المناقشة الموقّرة، التي شرّفتني بحضورها، وأثرت هذا العمل بعلمها وخبرتها، حضوركم اليوم هو شرفٌ لي، وإضافة لا تُقدّر بثمن.
كما لا يسعني إلا أن أعبّر عن امتناني العميق لمشرفي الكريم الدكتور محمد الأمين ولد مولاي إبراهيم الذي كان نِعم الرفيق في درب البحث، ونِعم الداعم في لحظات التشتّت والتعب، فله مني كل الامتنان والعرفان.
ولا يفوتني أن أوجّه تحيّة قلبية لكل من حضر وآزر، من أهلٍ وأصدقاء، زادني وجودكم ثباتًا، وأشعرني أن هذا الطريق، مهما طال، لا يكون صعبًا حين يُضاء بمرافقة من نحب.
هذا العمل، وإن كان يحمل اسمي، إلا أن وراءه قلوبًا كثيرة، ودعوات لا تُحصى، وسواعد خفيّة شاركت في كل خطوة… فلكم جميعًا جزيل الشكر وعميم التقدير.
أساتذتي الكرام
في ركن قصيٍّ من جغرافيا الذاكرة العربية، حيث الكلمات تُصاغ من رمل الصحراء وعطر الحرف، وبين كثبان شنقيط ومجالس محاظرها العامرة، نشأت نصوص نثرية حاذت من البيان حظّه، ومن البلاغة مداها، لكنها ـ وإن علت ـ بقيت حبيسة الرفوف، متوارية في زحمة الدرس النقدي الحديث، وفي ظل طغيان الشعر وهيمنته. تلك النصوص ليست إلا المقامات الموريتانية، التي شاءت لها الأقدار النقدية أن تعيش في الظل، رغم أنها تمثل أحد التجليات الكبرى لتطور الوعي السردي في الثقافة الموريتانية والعربية على السواء.
لقد أجمع أهل الدرس على ثراء المدونة النثرية الموريتانية وغناها، غير أن هذا الإجماع لم يُترجم إلى أعمال منهجية تكشف عن مكنوناتها السردية والفنية. وكأن النثر، في بلاد عُرفت بـ"أرض المليون شاعر"، ظل يُرى بعين الريبة أو التهميش، فقلّ من عرّج عليه أو تفكّر في شؤونه الجمالية. غير أن "ما لا يُدرك كلُّه لا يُترك جُلُّه"، وعلى خطى خليل النحوي إذ قال "وجب قضاء فائتة مطلقا"، انبرى هذا البحث لردّ بعض الجميل، وكشف بعض الغطاء، مساهمةً في الإنصاف المنهجي لأدب طواه النسيان دونما مبرر علمي أو نقدي.
والمقامة ـ وهي في جوهرها شكل من أشكال السرد العربي التراثي ـ لم تكن نشازًا عن سياقها الزماني والمكاني، بل جاءت امتدادا لميراث بلاغي وسردي عريق، تضرب جذوره في الهمذاني والحريري، وتورق أغصانه في أدباء شنقيط من ابن ذي الخلال إلى ولد الشاه. هي لا تمثل مجرد "نوع" أدبي، بل هي مرآة ثقافية، تُظهر كيف استقبل الشناقطة خطاب النثر، وأعادوا إنتاجه بما يتلاءم مع محيطهم اللغوي، والديني، والاجتماعي.
تسعى هذه الأطروحة إلى إنصاف هذا الشكل الأدبي، بتأطيره في سياقه السردي، وتحليله عبر عدسة منهجية متأنية، تعتمد السرديات التوسعية، بوصفها أداة نقدية تكشف البُنى العميقة للنصوص، وتفكك آليات اشتغالها، دون الارتهان لافتراضات مغلقة، أو مقاربات اختزالية. وقد آثرنا ـ في هذا المقام ـ الوقوف عند سردية المقامة في تجلياتها الثلاث: لحظة الظهور، ولحظة التحول، ولحظة التحديث، مستنطقين نصوص ابن ذي الخلال، وولد حامد، وولد الشاه، في محاولة لاستجلاء ملامح التكون، ومسارات التحول، وجماليات الكتابة.
وقد وجدنا في السرديات الوصفية خير معين على تحليل هذه النصوص، التي كثيرا ما اختلط فيها الخطابي بالسردي، والفقهي بالتعليمي، والبلاغي بالتعبيري. إنها مقامات تحفل بالمفارقة، وتبطن التهكم، وتلمّح أكثر مما تُصرّح، وتجمع بين الصنعة اللفظية، وعمق المعالجة الواقعية.
لقد كان اختيار المقامة نابعًا من وعي بحثي لا محض انتقاء عشوائي، فهذه النصوص ـ على قصرها أحيانا ـ تؤسس لنثرية أصيلة، تتجاوز النثر الفقهي أو التقريري، إلى نثر فني متخيل، تُسند فيه البطولة إلى اللغة، ويتحول فيه السارد إلى صانع متعة، وناقد واقع، ومؤرخ ضمني لتحولات المجتمع.
وقد أثبتت هذه الدراسة، من خلال التحليل والمقارنة، أن المقامة الموريتانية ليست مجرد امتداد للمقامات المشرقية، بل هي خطاب سردي ذو خصوصية، انفتح على الذاكرة الشنقيطية، وعايش تحولات الواقع المحلي، واندمج مع أدوات السرد الحديثة دون أن يتنكر لجذوره. فهي نصوص عابرة للأنواع، متفاعلة مع المرجع الثقافي، وفية لروح السرد العربي.
ولئن كانت هذه الأطروحة تُعدّ استكمالاً لما بدأناه في دراسات سابقة ـ لا سيما بحث "شعرية المقامة عند المختار بن حامد" في مرحلة الماستر ـ فإنها أيضا لبنة في مشروع أوسع يروم ردّ الاعتبار للسرد الموريتاني، الذي يستحق ـ عن جدارة ـ موقعه في خريطة السرد العربي، لا على سبيل التبعية، بل من باب التمايز والمساهمة والإبداع
لا نجد غضاضة في جوب مهامه هذا النثر الغفل، ورصد ظواهره المتناثرة والمتنافرة، ولو كان دون ذلك "خرط القتاد"، فما وضعنا عليه اليد من هذا النثر في شنقيط أو موريتانيا، ولو كان نزرا قليلا من فيضه اللامتناهي، يمثل حلقة مجهولة أو مفقودة من تاريخ النثر العربي عامة والمغاربي خاصة، وهي حلقة جديرة بمجابهة قضاياها الكبيرة، ومواجهة أسئلتها المتشعبة بالدراسة والتحليل المعلل والمطول، والشرح المفصل.
إنها مغامرة قد لا تفضي إلى مداها المنشود، لكنها في كل الأحوال محمودة العواقب، وقد أناخت راحلتها، وحطت طائرتها في المدرج بعد رحلة سيزفيه لم تبلغ مبتغاها وغايتها، لكنها ترجو أن تكون شاركت مشاركة ولو متواضعة في إنارة بعض قضايا هذا النثر المعتمة، وفاء لحق عطاء علمي وأدبي مجهول ومعلوم في مدة طويلة.
تسعى هذه الأطروحة المتواضعة إلى إنصاف النثر الموريتاني بالغوص في مجهوله، وإيقاظ نصوصه من مرقدها الأبدي، ومقاربتها مقاربة علمية، محايدة، متجردة، يمتشق صاحبها منهج السرديات في بعدها الانفتاحي، لأنها توخت دراسة السرد دراسة فنية تحليلية، قابلة للقياس، وبعيدة عن الافتراضات غير المبررة.
أما غايتنا النقدية فهي دراسة هذه المقامات وتصنيفها في الخانة السردية الملائمة لها، متوسلين في ذلك بمنهج نقدي محدد هو "السرديات" باعتبارها الفرع المختص من "الشعرية" بدراسة السرد وأشكاله، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المقامات الموريتانية لم تكن غفلا من الدراسة، فقد تناولها قبلنا باحثون، غير أنهم في مجملهم لم يهتموا بالجوانب الفنية والسردية من المدونة المقامية، وإنما قاربوها بمناهج تاريخية، تهتم بالمضامين السردية في علاقتها بالسياق وبسيولوجيا الأدب.
تسعى إذن هذه الأطروحة المعنونة ب"سردية المقامة في الأدب الموريتاني: سياق الظهور وخصوصية النص" في أبعادها التطبيقة إلى الكشف عن مكان السردية ، ومآتي الحسن والجمال في المقامة الموريتانية، كما كتبها الكتاب الشناقطة قديما، والموريتانيون حديثا في لحظات تطورها الث(لحظة الظهور، ولحظة التحول، ولحظة التحديث)، لاث ؛ وفق منهج نقدي محدد ولغايات علمية ومنهجية مضبوطة، والمنهج النقدي المتبنى هنا أداة لإنتاج المعرفة واختبار الأطروحة يتبنى السرديات وتطبيقاتها على النص السردي، في خياريه الوصفي (الواصف لسردية المقامة)، والتاريخي (المؤرخ لظهورها في التجربة الشنقيطية، وهما خياران يدخلان في اللحظة الثانية من مراجعة أطروحة السرديات التوسيعية، ويكشفان عن مستويات من الوعي بأطروحة السرديات ما بعد الاكلاسيكية في التجربة العربية، والتي تعمقت مداركها النظرية والمنهجية، مع ظهور الجيل الثالث من السرديين العرب المنشغلين بتطبيقاتها في الترجية العربية.
تدخل إشكالية الأطروحة إذن في إطار الأفق العام لتطبيقات السرديات على الأنواع السردية القديمة حيث سعينا إلى العودة إلى مدونة المقامة الموريتانية باعتبارها نوعا سرديا قديما حديث الظهور في الأدب الشنقيطي، لنمارس عليه مستوى من الوصفية ضمن ما يسمى بالسرديات الوصفية للكشف عن خصوصية السردية فيه من خلال تتبع التغيرات التي حصلت على مستوى الخطاب وعلى مستوى النوع نفسه، والتحولات النصية، وانتهينا إلى جملة من الاستنتاجات التي أكدت كفاءة السرديات الوصفية في وصف سردية النوع السردي القديم، ...
وأدت إلى الوقوف على التحولات النثرية التي أنتجت النوع السردي أي السرديات النثرية باعتبارها مدخلا من مداخل التأريخ للأنواع السردية والتي بينت أن الأنواع تظهر نتيجة هيمنة نثرية وتراكمات نثرية معينة
وانتهت إلى خصوصيات متعلقة بالنوع كتحول نص المقامة من نص طويل إلى نص قصير نسبيا
يأتي موضوع هذه الأطروحة "سردية المقامة في الأدب الموريتاني: سياق الظهور وخصوصية النص" ملبيا حاجة بحثية ومنهجية، بحثية تتعلق باستكمال ما بدأناه من دراسة تتعلق بتعميق المدارك النظرية والمنهجية لدراسة السرد التراثي الموريتاني في مشغله المتعلق بالسرديات التراثية، والسعي للكشف عن خصوصيات هذا السرد في علاقته بالسرد العربي، وفي مشغله المنهجي يختبر قدرة السرديات الوصفية على وصف سردية النص التراثي (المقامة)، مستكملا ما بدأناه في بحثنا الذي أعددناه في مرحلة "الماستر" حول "شعرية المقامة عند المختار بن حامد: الصيغة نموجا (بحث في سردية الشكل)"
وتكملة لهذا الجهد وتوسعا في مشغله وتوسيعا لمشروعنا البحثي التراثي المهتم بالمدونة "المقامية" في شنقيط وموريتانيا، اخترنا المضي قدما في مسعانا البحثي هذا، تحدونا رغبة جامحة في إنصاف مدونتنا المغموطة حقها في الدراسات الأدبية والنقدية، رغم ثرائها وتنوعها الذي يجعل البحث فيها مغريا وممتعا، وبتحقيقنا لهذا الإنصاف نحقق غاية منهجية تتعلق باستكمال مشروعنا البحثي المهتم بجانب مهم من المدونة السردية التراثية العربية ما يزال البحث فيه ضامرا بالموازنة مع مستويات بحثية أخرى شعرية وسردية، باعتبار أن معظم النظريات النقدية الحديثة المهتمة بالنص السردي في هذه البلاد تشكلت وتطورت تطبيقاتها في دائرة الاهتمام بالسرد الحداثي (النص الروائي، القص القصير)، فيما ما زال حظ النص التراثي منها محدودا.
سعيا لتطبيق أطروحة السرديات واختبار أدواتها المنهجية، يأتي هذا البحث ليطرح قضايا نقدية، ويثير أسئلة منهجية، تتعلق القضايا النقدية بوصف سردية الخطاب في نصوص مدونة "المقامة"، كما كتبها الكتاب الشناقطة والموريتانيون في لحظات تطور كتابة المقامة الثلاث (لحظة الظهور، ولحظة التحول، ولحظة التحديث)، وهي قضايا تأخذ أبعادا نظرية ومنهجية، تتصل النظرية منها بسياق ظهور المقامة في بلاد شنقيط، وتحولاتها اللاحقة على النشأة، وما رافق تلك التحولات من ملامح سردية شكلت خصوصية للسرد التراثي في هذه البلاد (خيار السرديات النثرية). ويتعلق السؤال المنهجي بقدرة السرديات الوصفية على وصف سردية النص التراثي (المقامة)، ومدى مواءمة السرديات التوسعية في خيارها التمددي في الوقوف على مأتي الحسن في النص وجمالياته، باعتبارها خيارا منهجيا كاشفا لما لم تتمكن السرديات الحصرية من إضاءته من مساحات سردية متصلة بطرائق تكثيف المتخيل ومستويات اللغة (خيار سرديات التمدد)، كما يشتغل البحث بوصف سردية المقامة في مدونتنا المدروسة (ذو الخلال، ولد حامد، ولد الشاه)، وهي مدونة نسعى إلي الكشف عن ملامح السردية فيها، ومآتي الحسن فيها، ومستويات الإمتاع والأنس ، للوقوف علي منابت هذه السردية ومصادرها المتعددة.
وقد أنجز هذا البحث وفق خطة منهجية، تكونت من مدخل نقدي، وثلاثة أبواب، وسبعة فصول، وخاتمة.
في المدخل النقدي حاولنا إضاءة جانب من السرديات يسعى في تطبيقاته لدراسة المنتج السردي والتأريخ له عبر الاهتمام بزمنية التشكل الفني للنصوص وربطها بتواريخ كتابتها، وظهورها وسياقات تحولاتها المختلفة، كما يهتم بدراسة خطاباتها وطرائق اشتغال مكوناتها داخل النص السردي. كما حاولنا رصد تحولات المنهج والاختلافات والمراجعات التي عرفتها السرديات التوسيعية في أبعادها التنظيرية وممارستها التطبيقية، ضمن مسار المراجعة والتنوع والتجديد في آليات المنهج وأدواته النقدية، مع تطوراته في التجربتين الغربية والعربية بفعل التراكمات النقدية التي حققها هذا المنهج في هذين الفضاءين خلال العقد الأخير من القرن العشرين ، تلك التراكمات التي طالت النظرية والأدوات ، مما أدى إلى تنامي الوعي بالمنهج النقدي "السرديات"، وتعدد تطبيقاته وتنظيراته في حراك بحثي سردي ساهم إلى حد كبير في تعميق الوعي النقدي بهذا المنهج تصورا وأدوات.
أما الباب الأول المعنون بـ"سردية المقامة سياق الظهور وإرهاصات التشكل" فقد خصصناه للحديث عن سياقات ظهور الشكل "المقامي" في السياق العربي والمحلي على التوالي في الفصلين الأول والثاني.
أما الباب الثاني فهو بعنوان سردية الخطاب في مدونة نصوص المقامة الموريتانية: في وصف سردية المتتاليات، وقد تناولنا فيه عبر ثلاثة فصول: وصف سردية الخطاب في نصوص مدونتنا المقامية، حيث سعينا لدراسة بنياتها الخطاب في هذه المدونة، والكشف عن بنياتها الخطابية ومتتالياتها السردية من خلال اتخاذ عينات من نصوص المدونة في لحظات الثلاث (لحظة الظهور، والتحول، والتحديث)، حيث خصصنا الفصل الأول لوصف سردية الخطاب في نصوص لحظة الظهور، متخذين من نصوص ابن ذي الخلال نموذجا، فيما وصفنا في الفصل الثاني سردية الخطاب في نصوص لحظة التحول أو الفحولة مع ولد حامدن ، وفي الفصل الثالث وصفنا سردية الخطاب في نصوص لحظة التحديث مع ولد الشاه.
أما الباب الثالث المعنون بــ " سردية المقامة والتعالق مع السرد العربي (خصوصية النص)، فقد قسمناه لفصلين تناولنا في أولهما تعالق المقامة الشنقيطية مع المقامة التراثية (النثرية التراثية الشنقيطية)، فيما خصصنا الفصل الثاني لتعالق المقامة الموريتانية مع أشكال السرد الحديثة (النثرية السردية الحديثة)، وما أحدثه التعالقان من طرائق لتشكل الخطاب وتأثير على سردية النص السردي التراثي المحلي، أظهرت سردية من القول متجذرة في الحواضن النثرية الشنقيطية، ومستويات تطويع الفصحى فيها، واستقبالها لنص المقامة، وهو ما كشف عن خصوصية محلية للسرد التراثي الموريتاني (المقامة الشنقطية). وقد ختم كل باب من الأبواب الثلاثة بتركيب، ثم أخيرا جاءت الخاتمة التي حاولنا أن نسجل فيها أهم النتائج التي أكدها البحث أو انتهى إليها.
النتائج:
لقد أدى بنا الوصف والتحليل في الأبواب والفصول السابقة إلى مجموعة من الاستنتاجات التي بسطنا لها في البحث (التركيب)، نريد هنا أن نتوقف عند أهم هذه النتائج التي انتهى إليها البحث أو أكد عليها.
فقد انتهى البحث إلى ما يلي:
1 ــ أن ظهور النص السردي التراثي ممثلا في المقامة كان نتيجة لتراكمات نثرية أدى إليها مستوى تطويع اللغة العربية في حواضنها ومحافلها الشنقيطية، وهي التراكمات التي أدت إلى ظهور النثرية الأدبية الشنقيطية المولدة للخطاب السردي التراثي. وأن هذا الظهور لم يكن نتيجة لعوامل اجتماعية وثقافية عرفها المجتمع العربي في بلاد شنقيطة على نحو ما بسطت له الدراسات النقدية التاريخية وأصحاب الطرح السسيلوجي في الأدب. فمن النتائج التي أكد عليها البحث ما يتعلق بكفاءة السرديات كخيار منهجي في دراسة النص السردي والتأريخ له، وما يتيحه هذا الخيار من موامة وملاءمة مع النص السردي، ومن كفاءة وصفية وتحليلية، فقد أبانت الأطروحة وخصوصا في جانبها التحليلي الوصفي عن ملاءمة هذا التصور المنهجي السردي، في بعده التوسعي وخياره المنهجي لمساءلة النص السردي التراثي والكشف عن خصوصيته في في موريتانيا، وملامح شعريته وسرديته عند كتاب المقامة، لتثبت أن دراسة النص السردي ليست دراسة لبنية "مغلقة" على نحو ما يقدمه الخيار المنهجي للتحليل البنيوي للسرد، بقدر ما هي دراسة لخطاب سردي مجل لتشكلات النص وتحولاته وتفاعلاته المتعددة في سياقاته المختلقة، التي تساهم في تشكل البنية "المغلقة" للنص من جهة، وتمد الباحث بتفسير شبه علمي ونقدي لظهور أشكال الكتابة الإبداعية بخطاباتها وأنماطها المختلفة، فلا معنى ــ في نظرنا ــ للنص الأدبي حين يحصر في زاوية مغلقة، وتفرض عليه الإقامة الجبرية، ليحرم من ما يتيحه له تفاعله العام من تعالقات نصية مغنية له، فالنص الإبداعي إنما يتشكل عبر تراكمات لغوية (تحولات النثرية)، وسياقات ثقافية عامة (حواضن لغوية ثقافية)، هي ما سعينا إلى اختباره وفق ما تقترحه السرديات التوسيعية من مراجعة للسرديات الاكلاسيكية، تلك المراجعات التي مكنت السرديات من الانفتاح على النص السردي بمفهومها الواسع، الذي يجمع بين البعد التعبيري واللفظي للنص، من منظور توسيعي ينشغل بمستويات اللغة والمتخيل السردي وما يمثلانه من مركزية في الكشف عن ملامح سردي النص "السردي" التراثي؛ باعتبار أن سردية النص التراثي لا تأتي في الغالب من طرائق اشتغال (الزمن، الصيغة، التبئير)، وإنما تأتي من طرائق تكثيف المتخيل ومستويات الاشتغال باللغة.
2ــ أبانت الأطروحة عن أن تشكل النص السردي التراثي الموريتاني مرّ بسياقات عدة احتضنت أشكال كتابته، وتحولات نثريته التراثية، فكان ظهور نثريته الأدبية وليد تحول في التجربة الشنقيطية، ساهمت فيه عوامل خارجية وداخلية غيرت نمط الخطاب الأدبي المهيمن، ونقلته من الهيمنة إلى التعايش، ثم تبادل المواقع، تماما كما كان عليه الأمر في نشأة هذه الأشكال الأولى، فميلاد النص السردي التراثي الموريتاني جاء نتيجة تحول ثقافي واجتماعي على مستوى الأدبية التقليدية طال الممارسة وفعل التلقي، فالمبدع الميال إلى الشعر إنشاء وإنشادا تحرر من سلطة الخطاب الشعري التقليدي، وانفتح على الشعر الحداثي، موازاة مع منح مساحات تقبل كبرى للنص السردي.
3 ــ بينت الأطروحة أن أغلب النقاد العرب قد انشغلوا في دراستهم للمقامة بمستويات تطويع اللغة فيها أكثر من ما استرعى انتباههم متخيلها السردي نتيجية لدور الصيغة السردية وطرائق اشتغالها في النص المقامي في إنتاج سردية النص.
4 ــ خلص البحث إلى أن الشناقطة وإن غلبت عليهم صفة "الشعر" كما كرستها مقولة (بلاد المليون شاعر)، إلا أنهم اهتموا بالنثر، واستطاعوا أن يضعوا فيه بصمتهم المميزة، وما نصوص مدونتنا المقامية إلا تجل من تجليات إبداعهم في النثر، وهو إبداع قادر لا شك على التأثير في الذائقة تأثيرا يحولها من ذائقة شعرية إلى ذائقة سردية، وذلك ما كشفته الدراسة في شقها المتعلق بتعالق المقامة مع النثرية الحديثة.
ــ أثبتت الدراسة تنوع مدونة النصوص السردية الموريتانية، فمنها النص السردي التراثي الشنقيطي الذي يمتاح من النثرية التراثية المحلية، ومنها النص السردي الحديث المتعالق مع النثرية العربية الحديثة وأشكال كتابتها، وهما بعدان متعايشان في التجربة السردية الموريتانية، وإن سبق البعد التراثي البعد الحداثي.
5 ــ أكدت الأطروحة أن سياق ظهور الأشكال السردية التراثية بشنقيط أو "موريتانيا" لا يعدم تشابها إن لم نقل تطابقا بين سياق ظهورها ونشأتها الأولى في الجزيرة العربية، نظرا إلى أن ظهور المقامة في نشأتها الأولى كان نتيجة تراكمات نثرية أدت إلى ظهور السردية الأدبية العربية المولدة لأنواع السردية العربية القديمة ومنها المقامة.
6 ــ أكدت الأطروحة أن إشكال السردية التراثية إشكال متجذر على مستوى النص السردي التراثي العربي والمحلي في لحظات كتابته المختلفة، وذلك ما تثيره نصوص الأنواع السردية من المقامة والرسالة والكرامة والحديث... في المدونة السردية الموريتانية من حيث شكلها السردي وتصنيفها النوعي.
7 ــ أثبت البحث أن لحظة ظهور المقامة الموريتانية مع ابن ذي الخلال وصحبه سابقة على تجسيدها والوعي بها كتابيا في مرحلة ثانية مع ابن حامدن، وهي مرحلة سعى خلالها رواد المقامة الموريتانية هذه المرة إلى التوجه الفني للكتابة مع التوسل بالميسم اللغوي والطابع التعليمي، مضيفين إليها بعض التحسينات عن طريق العناية بتقنية الكتابة الفنية، والاهتمام بتوظيف عناصر الخطاب ومكونات القصة من خلال السرد الخبري الذي يعكس حضورا سرديا لافتا لمكونات الخطاب، ومستويات اللغة وحجم المتخيل السردي عبر ترابط فني داخلي تتم صياغة الحوار بين شخصياته بأسلوب نخبوي رصين يقتبس من القرآن ويضمن من الشعر.
8 ــ أكدت الأطروحة أن كتابة المختار ولد حامد جسدت لحظة الوعي بالمقامة كتابيا في موريتانيا فقد وصلت معه المقامة الشنقيطية فحولتها المحيلة لقوتها وغلبة شكلها وغزارته، فقد طوعها لأغراض اجتماعية وسياسية، وعُد ركنا من أركانها بموريتانيا، بل إننا نميل إلى تسميته بحريري موريتانيا، فالجهد الذي قام به في إطار تكريس الكتابة المقامية في موريتانيا، والشهرة التي أخذتها معه، إلى جانب قدرته على تطويعها للمواضيع الاجتماعية والسياسية تجعله جديرا بأن يحتل في موريتانيا المكانة التي احتلها الحريري في المشرق حينما اشتغل بالمقامات، فمن أصل 86 مقامة موزعة على 26 كاتبا ينفرد ابن حامدن بنصيب الأسد.
9 ــ مثلت المقامة الموريتانية في نظرنا حلقة وصل بين الشفاهية والكتابية في السردية العربية، كما مثلت قنطرة عبور من النثرية التراثية إلى النثرية العربية الحديثة في السياق الموريتاني، حيث تشكلت نصوصها شفاهية معانقة الألوان التعبيرية البلاغية، قبل أن تخضع لتحول آخر تشكلت معه كسرد كتابي مدون، في لحظة مغالبة بين النثرية التراثية والنثرية العربية الحديثة، أو في "انقلاب أبيض"، وفق تقنيات سردية معينة في توظيف العجيب وصوره الغريبة الخارجة عن المألوف، ومطوعة لكل تلك الفنيات لصالح البعد السياسي والاجتماعي.
10 ــ رأينا أن المقامة من الأشكال النثرية التراثية التي أدت إليها التراكمات اللغوية في الطبقة الوسطى من الكلام، ليتم تجذيرها في الطبقة العليا منه، فقد ظهرت في السياق الشنقيطي نتيجة تطويع النثر وتطور النثرية العربية في انتقالها من النثرية التواصلية إلى النثرية الأدبية، في لحظة أصبحت فيها قابلية إنتاج النص السردي موجودة عند متكلمي هذا القطر في عهد عبد الله العتيق ابن ذي الخلال وصحبه، فكان الظهور مع ابن ذي الخلال في ظل هيمنة النثرية البلاغية التي يكون فيها تطويع اللغة لإبلاغ حجة، أو تدريس علم، أو الدخول في مجلس، حيث كانت النثرية الفقهية هي المسيطرة، ما جعل المقامات يتم تلقيها محضريا تعليميا، ويتم إنتاجها في لحظتها الأولى للحاجة نفسها، ولكي تضمن البقاء والقبولية، وتسلم من جلد النثرية الفقهية توسلت بالبعد التعليمي، وكان الحضور الشعري فيها طافحا.وقد آذنت هذه اللحظة بانبلاج فجر مقامي في هذه الصحراء، متشعب الأغصان، يحث السير إلى الفحولة اللغوية والفنية والفقهية، وكان لذلك كله نتائج إيجابية على الشكل المقامي خاصة، وعلى النثر بصفة عامة، لم تتوقف عند مستوى الألفاظ والمصطلحات الجديدة بل تجاوزته إلى المضامين والصور ومستويات التخيل، وتطويع اللغة، لتتهيأ للنثر الموريتاني في لحظة الظهور المقامي هذه أسباب النمو والتمدد.
11 ــ حققت المقامة التحول الأدبي في لحظتها الثانية مع مُكمل بنائها المختار ولد حامدن، وأسست لتحول من النثرية التراثية إلى النثرية الحديثة، لتحقق بذلك تحولا في النثرية الأدبية وأدوات الكتابة، بحضور النثرية التراثية في احتضانها للنثرية الحديثة، وهو الاحتضان الذي حافظت معه المقامة الموريتانية على مستويات من الإمتاع والمؤانسة المجسدة لسردية المقامة في كتابتها الحديثة، وتجلى ذلك ــ مثالا لا حصرا ــ في التحولات التي حصلت عليها من الطول إلى القصر.
12 ــ كتبت المقامة الموريتانية في لحظة التحديث في أفق أشكال السرود القصيرة، في لحظة مغالبة بين النثرية التراثية والنثرية العربية الحديثة كان الهيمنة فيها للأخيرة، حيث رأينا أن إرهاصات لحظة التحديث "المقامي"، ــ كما سميناهاــ بدأت فعليا في ثمانينيات القرن الماضي وتحديدا في عام 1987م حين كتب سيدي أحمد بن علي مقامة "الوصواصية"، وكتب محمد الأمين ولد أحظانا "المدينة الحمراء"، لتلوح معها في الأفق لحظة التحديث التي تجاوزت فيها المقامة مرحلة المناهضة بين النثرية التراثية والنثرية الحديثة، معلنة الاتجاه نحو غلبة النثرية الحديثة، وأنجبت الساحة مقامات خرجت من حضن النثرية الصحفية وتحررت من الزخرفة اللفظية ومن الأسماء التراثية في المقامة العربية والموريتانية القديمة، فكما وجدنا في المقامة "الوصواصية" تخلصا مطردا من فنيات المقامة القديمة يطل علينا الراوي الجديد "الضغمان بن الوصواص".
في هذه اللحظة خفّت سيطرة السجع، وغاب تكلفه، واستهوت المقامة الموريتانية الشباب الذي وجد فيها متنفسا عن تكميم الأفواه، فسخرها للتعبير عن الظلم والفساد السياسي والاجتماعي، وانتشار الرشوة والاختلاس.
13 ــ أكدت الأطروحة أن نص المقامة في التجربة الشنقيطية ظهر نتيجة لتراكمات نثرية أدى إليها تطويع الفصحى في الحواضن اللغوية الشنقيطية، أدت لاحقا إلى احتضان الخطاب السردي؛ وبالتالي فهي وليدة هذه الخبرة من الكتابة الأدبية المتعالقة مع المقامة العربية القديمة من جهة، والسردية الحديثة من جهة أخرى، فقد أدت هذه التراكمت النثرية والتحولات في خطابها إلى ظهور مساحة من الإمتاع بالمكتوب مصدرها ليس الوزن والتقفية، ولا التركيب، وإنما الانفتاح على المرجع الاجتماعي بالنسبة للشعر، والإمتاع بالإفاضة من القول بالنسبة للنثر؛ فظهرت أشكال نثرية منها المقامة كأداة أدبية منتجة لجمالية من القول بنصوص معينة، ستأخذ في ظهورها الأول ملامح الذاكرة مجذرة سلطة نثريتها في اللغة والمتخيل لعلاقتهما بالذاكرة، ومتعالقة مع نثرية تراثية مستقرة جذعها الأساسي القرآن والحديث وبلاغة العرب (النثرية التراثية الفقهية)، فجاءت متعالقة مع النص العربي الذي كتبت في أفقه خاصة المقامات الهمذانية والحريرية، لتنتج نصا محاكيا مماثلا ومشاكلا ومشابها لسابقة في السياق العربي رغم تمحضه نصا قصيرا تبرز قوته فيما تحمل شعريته من كثافة، فمقامات الهمذاني بلغت 200 صفحة أحيانا بينما لا تتجاوز المقامة عند ابن ذي الخلال الصفحتين، ويعود ذلك إلى أن المقامة في نشأتها الأولى ظهرت على شكل رسالة واتكأت على سلطة الكتابة، بينما اتكأت على الذاكرة الارتجالية في ظهورها الأول بشنقيط فجاءت قصيرة.
14 ــ لقد انتهى البحث إلى أن المقامة في لحظتها الثانية (لحظة التحول التي قادها ولد حامدن) نصا قصيرا لكنه مخالف في أدبيته، مجدد في سلطته، وهو نص السلطة (1940 ــ 1960م)، الذي يمتاح من سردية مخالفة تماما للسردية السابقة، تتعالق مع الرحلة لتأخذ منها سردية من القول تدخلها في الأدبية وتخرجها من الخطابة (اللحظة البلاغية)، قبل أن يتفتت في اللحظة الثالثة مع بداية ثمانينيات القرن الماضي نموذج سرديتها لصالح سردية القص القصير، فيفقد سلطته وتتراجع نثريته (الفقهية )، وتتحول جمالية سلطة خطابه من المتخيل ومستويات اللغة (ذات العلاقة بالذاكرة)، إلى سلطة الزمن والصيغة والتبئير (ذات العلاقة بالإبصار والسمع والأحداث)، وتكون نتيجة هذا التحول أن يصبح ظاهر النص مقامة وباطنه تتنازعه المقامة والحديث والقص القصير...فالمقامة إذن كالشعر كتبت في أفق سلطة المرجع الذي لن تتحرر منها إلا في تحللها لصالح النثرية الحديثة، ذلك التحلل الذي سيخرجها من التعالق مع النثرية التراثية ليدخلها في تعالق مع النثرية الحديثة.
15 ــ انتهى البحث إلى أن المقامة الموريتانية لها خصوصيتها التي جذرت شكلها على مستوى سياق التشكل (السياق)، ولحظة الإنشاء (الإبداع)، وشعرية الشكل (السردية)، وهي خصوصية من ملامحها انفتاح نثرية المقامة في لحظتي تشكلها وتحولها على فضائها المكاني والزماني الخاص بمظهره البدوي، وهو ما انعكس في ترجمة مخيلة نصوص لحظة التشكل بخطابات ذات خصوصية في انفتاحها على الديني من جهة (النثرية الدينية)، وعلى الشعبي والمحلي من جهة أخرى (المعجم الشفاهي الشعبي، والنظم ومظاهر الحياة اليومية)، وفق ما يعكسه اهتمام السارد في هذه اللحظة برصد مظاهر الحياة الموريتانية المرتبطة بالفضاء البدوي، ومظاهر العيش المألوفة البسيطة في نظمها، والعاكسة لبساطة المجتمع البدوي الخالي من تعقيد المدنية وظواهرها (سردية البادية)، فهذا ابن ذي الخلال في مقامته "السليمانية" يرسم سمات خصوصية نصه بريشة نثرية منفتحة على التراث المحلي حتى في مفرداته الحسانية التي منها "بابي" وهو رحل منسوب لصاحبه، وفعل "مر" التي بمعنى ضاع، أو فقد، وقد ورد في قول المرأة (مات أو مر...)، وراحلتي وهي مؤنث الرحل لكنه استخدام محلي أكثر مما هو عربي، وهنالك أسماء المواضع (ددر، أجبون، انبط، ترقى)، وغير بعيد عن ذلك تتبدى لنا هذه المحلية من خلال لعبة "الدوامة" التي شبه بها ابن ذي الخلال سيره.
وتتجذر خصوصية الانفتاح على الفضاء المحلي مع ابن حامدن في انفتاحه على المحكي بفضاءاته المختلفة والمتعددة، بانيا خصوصية محكيه ذي المرجع الثقافي باستحضار نصوص التشريع "قرآنا وحديثا"، ونماذج الإبداع الشعري "أبيات شعرية"، والمنظومة العاداتية الشنقيطية خاصة في شرب الشاي، وتناول التدخين، وقرى الضيف، وفي التعلم...نلحظ هذا المنحى في المحاججة بين "شاهين" و"طابة" في المقامة "الشاهينية"، وفي إبراز ابن حامد لتقاليد الضيافة في مقامته العبيدية والأطارية، والإبراهيمية.
ولئن بين الوصف والتحليل لظهور المقامة الحديثة وسردية خطابها هذا التحور في الشكل في تحول المقامة من نص طويل إلى نص قصير، ومن غياب المب الملامح البارزة للوجه التراثي للمقامة، فإن هذه الخصوصية من التشكل لا تقتصر على نوع المقامة في تجربة كتابة السرد الموريتاني، وإنما سبق أن تمت ملاحظته في جنس الكرامة من خلال كتابة نص الكرامة في أفق القص القصير كما هو بارز في مجموعة "من كرامات الشيخ" لأستاذنا الدكتور محمد ولد تتا، حيث يظهر هذا التنازع في التصنيف بين شكل المقامة، وشكل القصة القصيرة، وهي المجموعة التي كانت محل دراسة من طرف الأستاذ محمد ولد عبد الحي في صنفها فيها "مقالا قصصيا"، في حين صنفها أستاذنا الدكتور محمد الأمين ولد مولاي إبراهيم باعتبارها "كرامة".
16 ــ أثبتت الأطروحة أن السارد في النص المقامي الموريتاني خاصة في لحظة تحديثه مع ولد الشاه وصحبه، لا يهتم بإطراب السامع ولا بلفت انتباه القارئ، كما لا يهتم بالبعد الفكاهي في نصه ـ كما فعل سلفه من المقاميين ــ وإنما يهدف من خلال نصه إلى انتقاد أوضاع قائمة، ونُظم وبنيات اجتماعية وسياسية وإدارية واقتصادية يعتبر أنها تطرح إشكالات في الواقع الموريتاني، فهو في متخيله ينحاز لدوائر الواقعية ليجذر من خلالها خصوصيته، تلك الخصوصية التي من ملامحها في لحظة "التحديث" تمحضه المقامة نصا قصيرا لا يتجاوز أحيانا الصفحة أو الصفحتين من الحجم الصغير، بخلاف سلفه في السياق العربي الذي بلغ عشرات الصفحات مع الهمذاني، وتجاوز الثمان عند الحريري.
17 ــ لقد أثبتت الأطروحة أيضا أن أشكال الكتابة تظهر نتيجة لتجذر نثرية ما، حين تكون تراثية تظهر الأشكال النثرية التراثية، وحين تكون نثرية حديثة تظهر الأشكال النثرية الحديثة.
18ــ أكدت الأطروحة كذلك أنه في النثريات العملة القديمة تطردها العملة الجديدة، وأن النثرية التراثية دائما في التجربة العربية وغيرها تتراجع بفعل ظهور النثرية الحديثة، وبالتالي لما كانت الهيمنة للنثرية التراثية ظهرت الأشكال السردية التراثية في شكلها الطويل الذي هو المقامة، ولما أدت لظهور النثرية الحديثة ظهرت الرواية في مقامها الطويل.
ــ أثبتت الأطروحة أن ظهور النثرية لا يأتي اعتباطا ولا فجاءة، وإنما يظهر تبعا لسنن التطويع اللغوي ضمن طبقاته الثلاث (تواصلية ــ بلاغية ــ أدبية)، فالنثرية تتطور وفقا لطبقات القول، وتولد أشكالها تبعا لذلك، فالطبقة التواصلية تؤدي إلى ظهور مستويات من الكتابة في انتقالها من الشفاهية إلى الكتابية، والطبقة البلاغية تؤدي إلى ظهور الخطابة، والترسل، والتدريس في المحضرة (قديما)، والصحافة (حديثا)، وبظهور الطبقة الأدبية تظهر الأشكال الأدبية.فالمقامة في النثرية الشنقيطية ظهرت عندما بلغت طرائق الاشتغال باللغة مستوى من الاحتراف، وبتطور هذا الاحتراف وفقا لطرائق اشتغال المكونات في النثرية الحديثة ظهرت الأشكال الحديثة من قصة قصيرة وأشكال سردية تراثية متمحضة، ثم لاحقا الرواية كمستوى مبين عن تجذر النثرية الأدبية، وهذا كله يثبت أن مداخل التأريخ للأدب حين ترتبط بتاريخ تشكل النص، ومستويات ظهوره، يمكن أن تفسر لنا الظواهر الأدبية بموضوعية، وتساعدنا في كتابة تاريخ للأدب انطلاقا من تاريخ اللغة ومستويات تطويعها، وبالتالي الحكم عليه من خلال مستويات من الوصف والتحليل التي تبين عن مستوى من الأحكام الموضوعية في تفسير الأدب، وهي أحكام ستكون مغايرة تماما للأحكام السيسيولوجية التي غالبا لا يتم الاتفاق عليها، لأنها لا تعطينا ما نمسكه بأيدينا، ولا تمنحنا مشتركات.
الصعوبات
لم تخل هذه الأطروحة من مصاعب محسوسة وملموسة، صاحبتها منذ أن كانت فكرة تراود صاحبها إلى أن أصبحت شيئا منجزا على الورق لا يدعي التمام لكنه يطمح إلى وضع بصمة في سجل ذهبي قليل من يدون فيه بحبر خالد
ولئن كنا في هذا الجهد العلمي نحاول سد بعض ثغرات البحث في مجال مهم من مجالات الإبداع، فإن عدم اشتغال الباحثين بالنص السردي التراثي منه والحديث في الأدب الموريتاني، وضع أمامنا كثيرا من العراقيل والصعوبات خلال إنجاز هذا البحث. كما تطرح إشكالية الجدة تحديا حقيقيا أمام الباحث في التراث السردي المحلي نظرا لغياب نماذج بحثية في هذا المجال، ما يجبر الباحث على أن يلهث خلف سراب معرفي لم يؤسس له بعد، وحتى حين نجد منتجا نقديا فإننا نجده يتجه لنموذج سردي حديث مغاير لنموذجنا هو نموذج "الرواية، والقصة"، بأشكال كتابتهما المختلفة.
ولا شك أن ثراء مدونتنا "المقامية"، وكثرة الأسئلة النقدية التي يطرحها نصها السردي تراثيا كان أو حداثيا، يجعل الباحث عرضة لمصاعب جمة، يأتي في مقدمتها ندرة الاشتال بالدراسات السردية عامة والسرديات التراثية خاصة في البيئات العملية الموريتانية، من ما لا يتيح بحثية سردية على غرار ما يجده الباحث المشتغل بدراسات الشعرفي الأدب الموريتاني، وهو ما يحرم الباحث المشتغل بالدراسات السردية من الاستفادة أو الإفادة.
رغم العوائق والصعوبات التي ذكرنا بعضها وأضمرنا بعضا تجنبا للإطالة، فإن عزيمة البحث والاحتضان التكويني الإشرافي الذي حظينا به خفف عنا مشقة البحث، وكان يدفعنا كل مرة لبذل المزيد، وعموما فإننا في هذا البحث لا ندعي كمالا، وحسبنا السعي لتجلية جوانب مختلفة متعلقة بالشكل السردي التراثي المحلي ذي الأشكال المتعددة، مساهمة في كشف الملامح العامة لسردية المقامة في التجربة الموريتانية التراثية والحديثة، باعتبار مدونتها عينة سردية تراثية لها خصوصيتها في كتابة المقامة العربية، وإعادة إنتاج نصوصها في السياقات الشنقيطية والموريتانية مثل ما كان لها خصوصيتها في حواضن تطويع اللغة العربية ببلدان عربية أخرى، ظهرت فيها النثرية العربية وراكمت مستويات من التطويع أدت إلى ظهور الأنواع السردية العربية التراثية منها والحديثة.
أساتذتي الكرام
يمر التاريخ المعرفي للإنسان بمنعطفين مفصليين يمثلان ذروة التحول في مسيرته العلمية.
أولهما لحظة التهجي، حين يتعلم الإنسان الحروف الهجائية، وهي البوابة الأولى إلى عالم المعرفة.
أما المنعطف الثاني، فهو هذه اللحظة التي نعيشها اليوم، حيث يجلس الباحث ليتلقى تصويبات دقيقة من أهل التخصص والتمحيص، ممن يمتلكون أدوات الفهم العميق والخبرة الراسخة، مما يجنّبه الوقوع في المسارات الخاطئة، ويقوده إلى نتائج أكثر دقة ورسوخًا.
وإذا كانت المرحلة الأولى تؤسس للبناء، فإن هذه المرحلة تُعنى بترميمه، وسدّ ثغراته، وتقويم ما اعوجّ منه. ولا تقل هذه الغاية شأنًا عن التهجي ذاته، بل ربما زادت قداسةً، إذ أن تصحيح المسار في ختام الرحلة المعرفية كفيل بأن يمنحها معناها الكامل وثمارها
إن البحث العلمي، في جوهره، لا يختلف عن تسيير شؤون الأمم؛ فكلاهما يقوم على الرؤية والتخطيط، ويثمر على المدى البعيد إذا أحسن القائم عليه فنّ القيادة والإلهام.
وكما يقول المثل الشعبي: "الرجل يبني حَلّة"، فإن الأستاذ الباحث قد يبني حللاً لا تُعدّ، حين يلقي بفكرة ناضجة في ذهن أحد تلاميذه، فتغدو تلك الفكرة بذرةً تُروى بالاجتهاد وتُصقل بالإخلاص، حتى تثمر معرفة نافعة تضيف لبنيان العلم لبنة، وللإنسانية خطوة إلى الأمام.
ففي البيئات العلمية قد تتحول الفكرة إلى مشروع علمي متكامل، ينمو بالتأمل، ويثمر بالبحث الجاد، حتى يغدو إضافة حقيقية إلى رصيد البشرية من المعرفة.
إن مساهمة الأستاذ لا تتوقف عند حدود التعليم، بل تتجاوزها إلى التكوين العميق، حيث يكون صاحبُ البصيرة منبتًا لأفكار تنمو في عقول أخرى، فتتطور وتتبلور، وربما تتجاوز حدود ما تصوره هو نفسه، في مشهد يشبه ما تفعله القيادة الحكيمة حين تؤسس بنية تُتيح للطاقات أن تزدهر وللأمم أن تنهض.
إن الأستاذ الملهِم يشبه القائد السياسي النابه: لا يقف عند حدود القرار، بل يستشرف أثره في الأجيال القادمة. إنه لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يزرع بذورًا من الفكر تتجاوز مداه، وتؤتي أُكلها في زمان غير زمانه، وربما على يد تلاميذ تلاميذه. وهكذا يُبنى المجد العلمي، كما تُبنى الأمم: بحسن الغرس، وطول النفس، ورعاية الثمرة حتى تنضج.
وحق لي في ختام هذا التقديم أن أتمثل قول شيخي العلامة محمد سالم ولد عدود رحمه الله في واويته المحاورة لأشياخه:
ومالي على ذاك المقام تسلط فإني من القرمين أخفض مستوى
ولكنه قد يبذل الجهد مقتــــــر وقد تكرم الأضياف والقد يشتوى